رواية السجين - التمرد على السلطة
رواية السجين
التمرد على السلطة
منشورة في مجلة عالم الكتاب - عدد 13
تقول كيمبرلي رينولدز أن ثمة إشكالية تتعلق بأدب الطفل،
وهي أن الكتابات الجديدة تتواجد جنبًا إلى جنب مع الكتابات القديمة المتراكمة في
أدب الطفل؛ وهي كتابات تم تأليفها عندما كانت الأفكار مختلفة للغاية، ولا تتعلق الاختلافات
فقط بالكيفية التي نفهم بها الأطفال، في أعيننا المعاصرة، بل أنها تبدو بعيدة كل
البعد عن الانتماء إلى جنس أدب الأطفال، وكثير من هذه الكتب لا يقرأها الآن
الأطفال، بل تدرس بشكل أكاديمي في الجامعات، حتى فتح ذلك بابًا للجدل؛ هل لا تزال
تعتبر جزء من أدب الأطفال أم لا؟
إن كلمات أستاذ
أدب الطفل لا يمكن حصرها حول أدب الأطفال فقط ، بل تتسع لتشمل كتابات أخرى، من
الصعب فهمها في عصرنا هذا، رغم عظمتها، وخير مثال على ذلك ملحمة الكوميديا الآلهية
لـ دانتي أليجييرى، التي يتوه القارئ أمامها دون الرجوع إلى الهوامش، ومعرفة ظروف
عصرها السياسية.
إن غربة القارئ أمام بعض النصوص القديمة يمكن فهمها من
منظور "جاكوبسون" في عملية التوصيل، بأدوات علم الأسلوب، الذي يشمل
النص، بعمليات الإنتاج والتلقي؛ فالنص رسالة – بمفهومها التواصلي- إبداعية موجهة
إلى قارئ يعيد تكوين هذا النص، وعندما يقع نص قديم في يد قارئ معاصر، فهو ليس
القارئ المستهدف الأول. هذه مشكلة أولى، يليها بعد ذلك مشكلات تتعلق بفهم ظروف
العصر، وتطور اللغة الأدبية؛ وهي في رأي سقراط؛ لغة تنحو إلى الإغراب وتفادي
العبارات الشائعة، وربما كان العمل القديم يمثل ثورة على الشائع، غير أنه يتحول مع
الوقت، وعن طريق إجتراره على يد أدباء آخرين، إلى شكل بال.
من هذا المدخل نستطيع أن نقرأ رواية السجين لصالح مرسي.
وصالح مرسي روائي، درس الفلسفة وتأثر بها، وظهر هذا واضحًا فيما يكتب. نال الشهرة
فيما قدم من أدب الجاسوسية، ولم ينلها فيما كتب من أعمال أخرى أكثر عمقًا. ورواية
السجين، تركت أثرًا كبيرًا في وقتها؛ يحكي صالح مرسي أن توفيق الحكيم قد طلب حضوره
– بشكل شخصي- لمناقشة الرواية في ندوة شديدة الخصوصية، لا يحضرها إلا ثلاثة: عائشة
عبد الرحمن، حسين فوزي، فؤادة دوارة. لم تكن مجرد دعوة، بل شرفًا، وأمرًا واجب
التنفيذ. كما أن صلاح جاهين كان معجبًا بشدة برواية السجين، واستطاع أن يتعرف على
المكان، الذي تدور فيه رواية السجين، رغم أنه غير مذكور بالاسم في العمل، نظرًا
لإجادة صلاح مرسي في رسم البيئة بكل ما تحمل من خصوصية. هذه الرواية التي أثارت
إعجاب الكتاب والشعراء الكبار في وقتها، قد يشعر قارئ اليوم أمامها بالغربة – رغم
ذلك. فلغة العمل كلاسيكية، تعتمد على الجمل الطويلة، باعتبارها الأقرب إلى روح
الرواية، وفقًا لتصور ذلك العصر. ذلك التصور الذي لا يزال ممتدًا إلى عصرنا اليوم،
عند بعض الأدباء؛ الميل إلى الاستطراد والتكرار، ومحاولة وصف كل التفاصيل، إنها
إرث المدرسة الواقعية بصورة أو أخرى. هذا الاستطراد والتكرار يؤدي إلى بطئ
الإيقاع، وقد يؤدي إلى شعور القراء بالملل، خاصة مع تجاهل الحاجة للتشويق، أو خلق الصدمة
الناتجة من كسر التوقع. هذه أشياء ضرورية في الرواية المعاصرة، ولدت على يد
المناهج النقدية الحداثية، مثل المنهج البنيوي، في النصف الأول من القرن العشرين،
ومع تطور علم اللغة، وعلم الأسلوب، فإن الرواية المعاصرة رأت طريقتها جيدًا. لم
تعد تميل للاستطراد، والتكرار، ولا تطرح أسئلة مباشرة؛ تضيق مساحة التأويل لدى
القارئ، بل على العكس، تقوم على التكثيف، والإيحاء، وادراك المفردة المشبعة
بالدلالات والموروثات. لقد أخذت الرواية من الشعر، وقصيدة النثر، والقصة القصيرة،
والومضة، في محاولة لإذابة الفروق بين الأنواع وصنع ما يعرف بشعرية النوع الأدبي.
هذه هواجس معاصر؛ كسر القوالب، والتجريب، لم ينشغل الأسبقون بها، لأنها ابنة
عصرنا، لذا من الظلم المقارنة بين عمل قديم ومعاصر، فهذه مقارنة لا تستوعب تطور
الأدب؛ وثورة أخرى، في عالم الأدب، قد تدفعنا للشك فيما نراه اليوم أفضل.
إذا تجاوزنا العقبة الأولى، وهي عقبة قد نقابلها في أي
عمل كلاسيكي، وغير مقتصرة على أسلوب صالح مرسي، فإننا نرى عملًا يضعنا في مأزق.
فالأسئلة التي يطرحها العمل، أسئلة شائكة بالنسبة للقارئ، أسئلة تتعلق بالله،
وبحرية الإنسان، وبمعنى وجودنا. وهي أسئلة مجاب عليها مسبقًا، إجابات لا ترضي
الكاتب، لكنها -ربما- تكون مرضية للقارئ؛ مما يخلق حالة من المقاومة، والعوم ضد
التيار الناتج من وجود حكم مسبق.
أما أحداث
الرواية تدور في فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر، وهي الحرب العالمية الثانية، التي
قسمت الأرض في صراعها العالمي، ونشرت الفقر والمجاعة والموت في معظم البلاد؛ وفي
مصر تحديدًا، كانت قوات الحلفاء تصادر الأرضي والممتلكات، وتضع يدها على المرافق
الهامة. إننا في هذه الحقبة نرى أمرًا لا يعد مفهومًا، في وقتنا الحالي، وهي
مناصرة المصريين للنظام النازي؛ فهو نظام مهزوم، والأنظمة المهزومة مدانة بجرائم
كبرى، عن حق، بينما الأنظمة المنتصرة رغم جرائهما في الحرب فإنها بريئة، مثل براءة
أمريكا وإدعائها أن الضرورة الأخلاقية هي التي دفعتها إلى ضرب اليابان بقنبلتين نوويتين؛
من أجل أنهاء الحرب بأسرع وقت، وبأقل أعداد للضحايا، مع شينطة اليابانيين في ذلك
الوقت؛ حتى يصير الكلام مقبولاً. إننا أبناء عصر جديد، نقرأ عن حلم المصريين
بانتصار هتلر، باعتباره المخلص، وبهذا الشكل نفهم ما لم نعاصره، معاناة المصريين
مع الاحتلال البريطاني. وفي هذه الحقبة نعيش مع طفل، لا نعرف اسمه، فوالده يناديه
طوال الوقت بـ "يا سيدنا الأفندي!"، وحبيبته أوظة تناديه بـ "يا
أسمك ايه؟"، ومع هذا الطفل نمشي في الشارع، من البيت إلى المحطة، لنعرف
نتيجته؛ هل نجح أم لا؟ وبرغم تكرار هذا السؤال، فإننا لا نتهم بالإجابة، بقدر ما
نهتم بحالة التشظي، التي يخلقها صالح مرسي، أمام الأماكن. ذكريات وحكايات تولد في
كل ناصية، ومن خلالها نخرج عن الزمن الفعلي، الواقعي، وهو ذهاب الطفل إلى المحطة
لمعرفة النتيجة، ونعيش زمنًا أكبر.
يلعب صالح مرسي بالزمن، الواقعي والمتخيل، ويدرك أبعادنا
النفسية؛ فالزمن يطول ويقصر وفقًا لانفعالتنا، وهو يتأرجح بشكل دائم على قول يوسا.
وهنا نرى حاجة الطفل للهروب الدائم، إلى لحظة أخرى، أكثر أمانا ربما، أو ربما
هروبًا من أجل الهروب، فيطيل المكوث في ذاكرة، لها أبعادها الكاملة، قبل أن ينقطع
هذا الشرود على يد أحد، فيعود ليمشي في الطريق إلى المحطة، ونرى الرواية تعتمد على
الصورة البصرية فتنقل لنا البيوت والشوارع، كأننا نشاهد فيلما سينمائيًا. ومن خلال
الأماكن التي نراها، قد ننتقل، من جديد، إلى ذكرى، أو حكايات؛ ترتكز على فكرة
القهر، والقهر الأبوي تحديدًا. يشعر الطفل بالتوق إلى الحرية على طول الخط، ومن
أجل هذا استهل صالح مرسي رواية السجين، إذ يقول "لم يعد يعنيه الآن سوى أن
ينال حريته!"(ص5)، وهذا التوق إلى الحرية يدفع الصغير تجاه أمنيات شريرة،
لكنها بشرية مع ذلك. إننا نرى أمامنا عقدة أوديب، كما رآه فرويد، فالطفل يعاني من
سلطة الأب، ويتمنى له الموت، رغم ما يشعر به تجاهه من حب، "كم يحبه، وكم
يكرهه!" (ص5)، وهذه العلاقة المعقدة بين الطفل والأب، تتحول إلى علاقة معقدة
بين الطفل والله أيضًا؛ "ترى ما شكل الله؟ لابد أنه يشبه أباه، أو يشبه
الملك!"، (ص 16)، وهذا يحيلنا إلى إشارة فرويد في الطوطم والتابو إلى الخلط
الذي يحدث في مخيلة الطفل بين صورة الأب والإله. إننا نرى فهمًا عميقًا للنفس
البشرية، وخاصة لمرحلة الطفولة، ومحاولة جادة لصياغة أفكار هذه المرحلة وهواجسها،
بما يتسق بعقلية الطفل؛ لكننا مع ذلك، نرى مسافة تبعد بين هذا السعي الجاد؛ وربما
إذا تم اختيار الطفل ليروي الحكاية لنا، لاستطعنا أن نتوحد أكثر مع أفكاره، دون
شعورنا بسلطة الراوي العلوية، كأننا – لسوء الحظ، ورغم محاولة الكاتب للثورة على
السلطة- نقع في النهاية فريسة لها.
لم تكن محاولة
البطل هي التحرر من سلطة الأب، فقط، بل كان القهر مصدره جميع الكبار، وهم
المحاصرون – بالضرورة- بقهر الاحتلال، وكل مقهور يصير مستبدًا، على كائن أضعف؛
الرجل على المرأة، والكبير على الصغير، وهكذا، كما أشار الكواكبي إلى ذلك في طبائع
الاستبداد. فإننا نرى الطفل محاصرًا وسجينًا، وبلا ذنب ظاهر في حقيقة الأمر؛
فالطفل، بشهادة الناظر "أحسن تلميذ في المدرسة"، ولكنه رغم ذلك
"عفريت.. شقي جدًا .. لا يطاق". (ص39)، وهكذا نتابع اضطهاد الجميع لهذا
الطفل الشاطر، والطاهر، ورجمهم بلا خطية له، رغم خطاياهم الكثيرة، والتي تتجلى،
مثلا، في كذب الناظر إذ قال "أنا مش كنت بديك دروس خصوصية ببلاش يا
ولد؟"، (ص42)، والطفل يقف حائرًا قبل أن يرد بنعم، خشية أن يصير قليل الأدب، لو
قال الحقيقة. إنها حيرة الطفل أمام عالم الكبار، أمام ما يعرف بالنضج.
الآن، إننا إذا
أردنا صياغة عقبتنا الأولى بشكل أوضح، فإن استهلال العمل يساعدنا على ذلك، إذ أننا
يمكننا أن نفهم فكرة الكاتب، وما يدور حوله العمل، من الجملة الأولى، ودون بذل جهد
كبير في قراءة العمل.
إننا -برغم
العقبة التي واجهناها- نستطيع أن نقول أننا أمام عمل ثري، وملغوم، ولا يتعامل مع
الكتابة باعتبارها عملية سهلة، بقدر ما يتعامل معها باعتبارها حقل ثقافي؛ مليء
بالرموز المتشابكة، وإن كانت تبدو مباشرة في قراءتنا، لكنها لا تفقد النص الحيوية
الضرورية ليظل متجددًا مع قارئ معاصر، ورغم أن الأسئلة الشائكة التي يطرحها العمل،
تطرق إليها أدب اليوم، بشكل أعمق، إلا أن متعة البحث في نص – يحتوي على منظومة ثقافية
مغايرة لعصرنا- تدفعنا إلى البحث فيما وراء الكتابة، وتدفعنا إلى محاولة تفهم عصر
قديم. إنها القيمة العظمى التي يقدمها الفن للإنسان: الذاكرة.
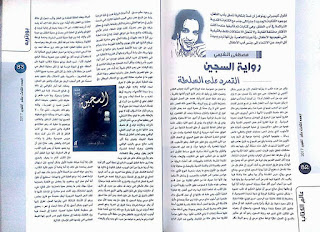


تعليقات
إرسال تعليق